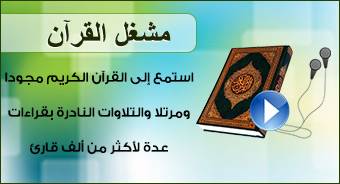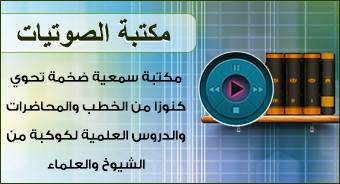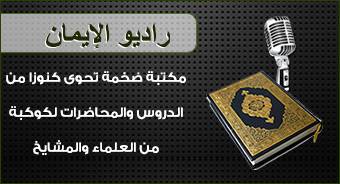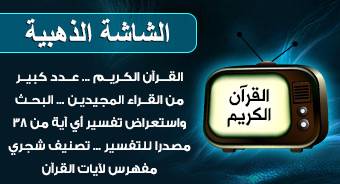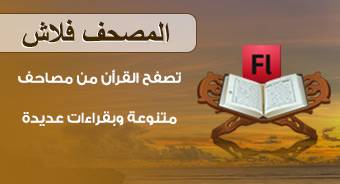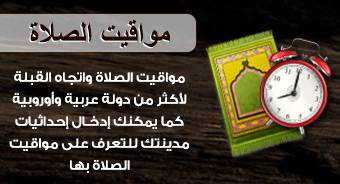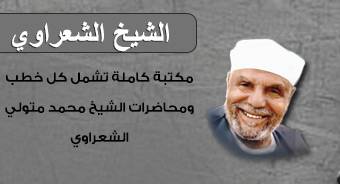.الطرف الثاني في معرفة ما يحتاج الكاتب إلى وصفه في أصناف الكتابة مما تدعوه ضرورة الكتابة إليه على اختلاف أنواعها:
.الطرف الثاني في معرفة ما يحتاج الكاتب إلى وصفه في أصناف الكتابة مما تدعوه ضرورة الكتابة إليه على اختلاف أنواعها:
ويشتمل على أنواع:
 .النوع الأول: مما يحتاج إلى وصفه النوع الإنساني:
.النوع الأول: مما يحتاج إلى وصفه النوع الإنساني:
وهو على ضربين:
 .الضرب الأول: أوصافه الجسمية:
.الضرب الأول: أوصافه الجسمية:
وهي على ثلاثة أقسام:القسم الأول ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهي عدة أمور منها: حسن اللون؛ والألوان في البشر ترجع إلى ثلاثة أصول؛ وهي البياض، والسمرة، والسواد؛ ويعبر عن السواد بشدة الأدمة، وربما عبر عن البياض برقة السمرة؛ ويستحسن من هذه الألوان البياض؛ وأحسن البياض ما كان مشرباً بحمرة؛ وقد جاء في حديث ضمام بن ثعلبة أنه حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفوده عليه بقوله: أيكم ابن عبد المطلب؟ قيل: هو ذاك الأمغر المتكئ: والأمغر هو المشرب بحمرة، أخذاً من المغرة؛ وهي الصبغ المعروف.وقد جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه: أزهر اللون؛ والأزهر هو الأبيض بصفرة خفيفة. والسمرة مستحسنة عند كثير من الناس، وهو الغالب في لون العرب، وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم:
«بعثت إلى الأحمر والأسود»، إن المراد بالأحمر: العجم لغلبة البياض فيهم؛ والمراد بالأسود: العرب لغلبة السمرة فيهم؛ أما السواد فإنه غير ممدوح بل قد ذم الله تعالى السواد، ومدح البياض بقوله:
{يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} الآية؛ على أن كثيراً من الناس قد جنحوا إلى استحسان السودان والميل إليهم، وتأنقوا في الاحتفال بأمرهم؛ وقد نص أصحابنا الشافعية على أنه لو قال لزودته: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق، لم تطلق وإن كانت زنجية سوداء؛ فقد قال تعالى:
{وصوركم فأحسن صوركم}. وبالجملة فالحسن في كل لون مستحسن؛ ولقائل:
إن المليح مليح ** يحب في كل لونومنها: حسن القدود الربعة: وهو المعتدل القامة، الذي لا طول فيه ولا قصر، وليس كما يقع في بعض الأذهان من أن المراد منه دون الاعتدال. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة. ويستحسن في القد القوام والرشاقة، ويشبه بالرمح وبالغصن، وأكثر ما يشبه به في ذلك أغصان ألبان لقوامها.ومنها: سواد الشعر؛ وأكثر ما يكون ذلك في السمر، فإن اجتمع مع البياض سواد الشعر كان ذلك في غاية من الحسن، ويشبه سواد الشعر بالليل؛ وربما وقعت المبالغة فيه فشبه بفحمة الليل، وبدجى الليل، وبفحمة الدجى؛ وقد يشبه بالآبنوس ونحوه مما يغلب فيه حلك السواد.وقد اختلف الناس في جعودة الشعر وسبوطته أيهما أحسن؟ فذهب قوم إلى استحسان الجعودة؛ وهي انقباض الشعر بعض انقباض، وهو مما يستحسنه العرب، وإليه ذهب الفقهاء حتى لو شرط البائع في عبد كونه جعد الشعر وظهر سبط الشعر رد بذلك بخلاف العكس؛ وذهب آخرون إلى استحسان السبوطة، وهي استرسال الشعر وانبساطه من غير انكماش؛ وأكثر ما يوجد ذلك في الترك ومن في معناهم. ثم الذاهبون إلى استحسان الجعودة يستحسنون التواء شعر الصدغ، ويشبهونه بالواو تارة وبالعقرب أخرى.ومنها: وضوح الجبين، وسعة الجبهة، وانحسار الشعر عنها؛ فيستقبح الغمم؛ وهو عموم الجبهة أو بعضها بشعر الرأس.ومنها: وسامة الوجه وحسن المحيا. ويشبه الوجه في الحسن بالشمس، وبالقمر، وبالسيف؛ إلا أن التشبيه بالشمس وبالقمر أتم من التشبيه بالسيف لما فيه من صورة الاستطالة؛ وقد جاء في بعض الآثار أنه قيل لبعض الصحابة رضي الله عنهم: هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ فقال بل كالشمس والقمر.ويستحسن في الوجه حمرة الوجنتين؛ ويشبه لونهما بالورد، وبالشقيق، وبالعقيق، وبالعندم؛ وما يجري مجرى ذلك مما تغلب فيه الحمرة المشرقة.ومنها: بلج الحاجبين وزججهما، فالبلج: انقطاع شعر الحاجبين؛ بألا يكون بينهما شعر يصل ما بينهما، وهو خلاف القرن؛ وربما استحسن الخفي من القرن، وهو الذي دق فيه شعر ما بين الحاجبين حتى لا يظهر فيه إلا خضرة خفية.والجج: دقة الحاجب مع طوله بحيث ينتهي إلى مؤخر العين؛ وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أزج الحاجبين.ويستحسن في الحاجبين سواد شعرهما، وان يكونا مقوسين؛ ويشبه تقويسهما بالنون تارة، وبالقوس أخرى.ومنها: حسن العينين؛ ويستحسن في العين الحور؛ وهو خلوص بياض العين؛ والمجل: وهو سعتها، ويقال فيه حينئذ: أنجل، وربما قيل: أعين، ومنه قيل للحور: عين والدعج؛ وهو شدة سواد الحدقة. الكحل؛ وهو أن تسود مواضع الكحل من العين خلقة.وتشبه العين بالصاد تارة، وبالجيم أخرى؛ وتشبه بالنرجس وربما شبهت بنور الباقلى؛ واعترض بأن فيه حولا. وربما شبهت العين بالسيف، وبالسهم، وبالسنان؛ وقد يستحسن في العينين الفتور وضعف الأجفان.ومنها: حسن الأنف؛ ويستحسن فيه القنا؛ وهو ارتفاع وسط الأنف قليلاً عن طرفيه مع دقة فيه، وهو الغالب في العرب؛ وقد جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم: أنه كان أقنى الأنف؛ ويستحسن فيه الشمم أيضاً؛ وهو استواء قصبة الأنف وعلو أرنبته.ويشبه النف بالسيف في بريقه.ومنها: حسن الفم؛ ويستحسن فيه الضيق، ويشبه بالميم، وبالصاد، وبالخاتم.ومنها: حسن الشفتين؛ ويستحسن فيهما الحمرة، وتشبه حمرتها بما تشبه به الوجنة من الورد والعقيق والمرجان ونحوها؛ ويستحسن فيهما اللمى؛ وهو سمرة تعلو حمرتهما.ومنها: حسن الأسنان؛ ويستحسن فيها الشنب؛ وهو بياض وبريق يعلوهما.. وتشبه الإنسان في البياض وحسن النظم باللؤلؤ، وبالبرد، وبالطلع؛ وهو نبت أبيض، وبالأقاح، وبالحبب؛ وهو الذي يعلو الكأس عند شجه بالماء؛ وقد تشبه بالجوهر؛ ويستحسن فيها الأشر؛ وهو تحديد الإنسان كما يقع في كثير من الصبيان؛ ويستحسن في النسخ وهو لحم الأسنان- حمرة لونه؛ ويشبه بالعقيق والورد وسائر ما يشبه به الخد.ومنها: حسن الجيد؛ وهو العنق؛ ويستحسن فيه طوله وبياضه من الأبيض؛ ويشبه بإبريق فضة.ومنها: دقة الخصر؛ وهو مقعد الإزار حتى إنهم يشبهونه بدور دملج، ودور خلخال وما أشبه ذلك.قلت: وهذه الصفات وإن كان مستحسنة في الرجال والنساء جميعاً فإنها في النساء أكد؛ فإن المر في الحسن منوط بهن؛ فمهما كانت المرأة أحسن كان أعظم لشأنها، وأعز لمكانها. وقد قيل لرجل من بني عذره: ما بال الرجل منكم يموت في هوى امرأة! إنما ذلك لضعف فيكم يا بني عذره، فقالك أما والله لو رأيتم النواظر الدعج، فوقها الحواجب الزج، تحتها المباسم الفلج، لا تخذتموها اللات والعزى! وقد أكثر الشعراء من التغزل بهذه المحاسن بما ملأ الدفاتر مما لا حاجة بنا إلى ذكره هنا.القسم الثاني ما يختص به الرجال وأخص ما يختص به الرجال من المحاسن: اللحية، وقد قيل في قوله تعالى:
{يزيد في الخلق ما يشاء}: إن المراد اللحية، على خلاف في ذلك؛ ويستحسن في اللحية استدارتها وتوسطها في المقدار، وسواد شعرها. فإذا حسنت اللحية من الرجل كملت محاسنه. وتزيد الأحداث على الرجال في الحسن بمقدمات ذلك؛ فيستحسن منهم خضرة الشارب، وخضرة العارض والعذار، ويشبه كل منهما بالآس، وبالريحان، وبدبيب النمل ونحو ذلك. قائلين: إن ذلك مما يدل على الشجاعة وهو أمر مطلوب في الرجال كما تقدم.القسم الثالث ما يختص به النساء ومما ينفرد به النساء من الوصاف الجسمية: السمن، فهو أمر مطلوب في المرأة ما لم يفرط ويخرج عن الحد المطلوب؛ ففي الصحيحين من حديث أم زرع: بنت أبي زرعٍ وما بنت أبي زرع؟ ملء كسائها، وغيظ جارتها إشارة إلى امتلائها بالشحم. ووصف أعرابي امرأة فقال: بيضاء رعبوبة، بالشحم مكروبة، بالمسك مشبوبة.وهذا بخلاف الرجال فإن المطلوب فيهم: الخفة وقلة اللحم لأجل قوة النهضة، وسرعة الحركة في الحرب وغيره، والسمن يمنع ذلك، مع ما يقال إن فيه تبليداً للذهن؛ قال بعضهم: ما رأيت حبراً سميناً إلا محمد بن الحسن يعني صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه. وربما استحسن قلة اللحم في المرأة أيضاً، وتوصف حينئذ بالهيف.ومن ذلك ثقل الردف؛ فهو مما يتمدح به من النساء بخلاف الرجل فإن ذلك فيه غير محمود.ومن غريب ما يحكى في ذلك أن رجلاً أخذ خطر من قوم على أن يغضب معاوية بن أبي سفيان مع غلبة حلمه، فعمد إلى معاوية وهو ساجد في الصلاة، فوضع يده على عجيزته وقال: ما أشبه هذه العجيزة بعجيزة هند! يعني أم معاوية، فلما سلم من صلاته، التفت إلى ذلك الرجل وقال: يا هذا إن أبا سفيان كان محتاجاً من هند إلى ذلك، وإن كان أحد جعل لك شيئاً على ذلك فخذه.ومما يستحسن في المرأة طول الشعر في الرأس، ودقة العظم، وصغر القدم، ونعومة الجسد، وقلة شعر البدن، في أمور أخرى يطول ذكرها.
 .الضرب الثاني: الصفات الخارجة عن الجسد:
.الضرب الثاني: الصفات الخارجة عن الجسد:
وهي على ثلاثة أقسام أيضاً ما يشترك فيه الرجال والنساء:القسم الأول وهو يرجع إلى أصلين العقل والعفة ويدخل تحت كل من هذين الأصلين عدة من أوصاف المدح:فأما العقل فيدخل تحته العلم؛ وصفاته: المعرفة، والحياء، والبيان، والسياسة، والكفاية، والصدع بالحجة، والحلم عن سفاهة الجهلة وغير ذلك مما يجري هذا المجرى. ولا يخفي أن هذه الأوصاف مطلوبة في الرجال والنساء جميعاً وإن كان أكثرها بالرجال أليق.وأما العفة فيدخل تحتها: القناعة، وقلة الشره، وطهارة الإزار، وغير ذلك مما لا يستغني عنه رجل ولا امرأة، وإذا ركب العقل مع العفة حدث عنهما صفات أخرى مما يتمدح به: كالنزاهة، والرغبة عن المسألة، والاقتصار على أدنى معيشة، ونحو ذلك مما ينخرط في هذا السلك.القسم الثاني ما يختص به الرجال دون النساء وهو يرجع إلى أصلين أيضاً؛ وهما العدل والشجاعة، ويدخل تحت كل من الأصلين عدة أوصاف من أوصاف المدح؛ فيدخل تحت العدل السماحة، والتبرع بالنائل، وإجابة السائل، وقرى الضيف، وما شابه ذلك. ويدخل تحت الشجاعة عدة أوصاف كالحماية والدفاع، والأخذ بالثأر، والنكاية في العدو، والمهابة، وقتل الأقران، والسير في المهامه الموحشة، وما أشبه ذلك؛ وإذا ركب العقل مع الشجاعة حدث عنهما صفات أخرى مما يتمدح به كالصبر على الملمات ونوازل الخطوب، والوفاء بالوعد ونحو ذلك.ما يختص به النساء القسم الثالث ويرجع إلى أصلين مذمومين في الرجل وهما الجبن والبخل وذلك أن المرأة إذا جبنت كفت عن المساوي خوفاً على نفسها أو عرضها، وإذا بخلت حفظت مال زوجها عن الضياع والإتلاف؛ وحينئذ فتكون أوصاف الرجال الممدوحة أربعة أوصاف: اثنان يشتركون فيهما مع النساء؛ وهما العقل والعفة؛ واثنان ينفردون بهما عن النساء؛ وهما العدل والشجاعة.وتكون أوصاف النساء الممدوحة أربعة أيضاً: اثنان يشتركن فيهما مع الرجال؛ وهما العقل والعفة؛ واثنان ينفردن بهما عن الرجال؛ وهما الجبن والبخل؛ فيمدح كل من الصنفين بما هو مشتمل بحسب ما يقتضيه المقام وما يوجبه الحال.قال قدامة بن جعفر الكاتب في نقد الشعر: ومدائح الرجال تنقسم بحسب الممدوحين من أصناف الناس في الارتفاع والاتضاع، وضروب الصناعات والتبدي والتحضر؛ فيحتاج إلى الوقوع على المعنى اللائق بمدح كل؛ فمدح الملوك يكون بما يلائم قدرهم من رفعة القدر وعلو الرتبة والانفراد عن المثل والقرين؛ كقول النابغة في النعمان بن المنذر:
ألم تر أن الله أعطاك سورة ** ترى كل ملكٍ دونها يتذبذببأنك شمس والملوك كواكب ** إذا طلعت لم يبد منهم كوكبوما يجري مجرى ذلك؛ ومدح الوزير الكاتب بما يليق بالعقل والدربة، وحسن التنفيذ والسياسة، فإن أضيف إلى ذلك الوصف بالسرعة في إصابة الحرم، والاستغناء بحضور الذهن عن الإبطاء لطلب الإصابة كان أحسن وأكمل للمدح كما قيل:
بديهته مثل تفكيره ** متى رمته فهو مستجمعوكما قيل:
يرى ساكن الأوصال باسط وجهه ** يريك الهويني والأمور تطيرويمدح القائد يعني المير الذي يقود الجيش بما يجانس البأس والنجدة، ويدخل في باب البطش والبسالة، فإن أضيف إلى ذلك المدح بالجود والسماحة والحذق والبذل والعطية كان أحسن وأتم، من حيث إن السخاء أخو الشجاعة، وهما في أكثر الأمور موجودان في ذوي بعد الهمة، والإقدام والصولة، كما قال بعضهم جامعاً بين البأس والجود:
فتى دهره شطران مما ينوبه ** ففي بأسه شطر وفي جوده شطرفلا من بغاة الخير في عينه قذى ** ولا من زئير الحرب في أذنه وقرقال: وتمدح السوقة والمتعيشون بأصناف الحرف وضروب المكاسب، والصعاليك بما يضاهي الفضائل النفسانية من العقل والعفة والعدل والشجاعة، خالياً عن مثل الملوك ومن تقدم ذكره من الوزراء والكتاب والقواد.ويمدح ذوو الشجاعة منهم بالإقدام الفتك والتشمير والتيقظ والصبر مع التحذق والسماحة وقلة الاكتراث بالخطوب الملمة ونحو ذلك.قلت: ويؤخذ مما ذكره قدامة أن القضاة والعلماء يوصفون بما يليق بمحلهم من ذلك، فيوصف العالم بثقابة الذهن، وحدة الفهم، وسعة الباع في الفضل؛ وما يجري مجرى ذلك، ويوصف القضاة بذلك وبالعدل والعفة ومباينة الجور ونحو ذلك؛ وستقف في قسم الولايات في نسخ البيعات والعهود والتقاليد والتواقيع والتفاويض والمراسيم ونحوها من ذلك بما يتضح لك به سواء السبيل.واعلم أن الكاتب كما يحتاج إلى معرفة الصفات المحمودة من النوع الإنساني كذلك يحتاج إلى معرفة الصفات المذمومة منه؛ فربما احتاج إلى الكتابة بذم شئ من ذلك فيكون عنده من العلم بالصفات المذمومة ما يتفق معه؛ كما حكي أن بعض العمال بعث إلى الرشيد بعبد أسود فقلب كتابه ووقع عليه: أما بعد فإنك لو وجدت عدداً أقل من الواحد، أو لوناً شراً من السواد لبعث به إلينا والسلام.ولا يخفى أن كل ما خالف صفة من الصفات المستحسنة المتقدمة فهو مستقبح، مع ما هو معلوم من الصفات المذمومة الجسمية، كالحدب والحول ونحوهما؛ ومن الصفات المعنوية، كسوء الخلق وبذاءة اللسان ونحو ذلك. وفي هذا مقنع في الإرشاد إلى المراد والتنبيه على القصد.
 .النوع الثاني: مما يحتاج إلى وصفه من دواب الركوب:
.النوع الثاني: مما يحتاج إلى وصفه من دواب الركوب:
وهي أربعة أصناف:الصنف الأول: الخيل:ويحتاج إلى المعرفة بوصفها في مواضع، من أهمها وصفها عند بعث شئ منها في الإنعام والهدايا، والجواب عن ذلك؛ ووصفها في ترتيب الجيوش والمواكب، وذكرها في مجالات الحرب، وما يجري مجرى ذلك؛ ويشتمل الغرض منه على معرفة أصنافها، وألوانها، وشياتها؛ وما يستحسن ويستقبح من صفاتها؛ ومعرفة الدوائر التي تكون فيها؛ والبصر بأمور أسنانها وأعمارها.أما أصنافها فثلاثة الأول: العراب؛ وهي أفضلها وأعلاها قيمة، وأغلاها ثمناً، تطلب للسبق وللحاق؛ والملوك تتغالى في أثمانها وتعدها لمهم الحرب؛ وتوجد ببلاد العرب ومحلاتهم في أقطار الأرض، كالحجاز، ونجد، واليمن، والعراق، والشام، ومصر، وبرقة، وبلاد المغرب وغيرها.الثاني: العجميات؛ وهي البراذين ويقال لها: الهماليج، وتعرف الآن بالآكاديش تجلب من بلاد الترك، ومن بلاد الروم، وغالب ما توجد مشقوقة المناخر، وتطلب للصبر على السير وسرعة المشي.الثالث: المولد بين العراب والبراذين؛ فإن كان الأب عجمياً والأم عربية قيل له: هجين، وإن كان بالعكس قيل له: مقرف؛ وهي تكون في الجري والمشي متوسط بين النوعين.وأما ألوانها فقد ذكر ابن أبي إصبع: أن أصول الألوان فيها ترجع إلى أربعة ألوان، وما سواها مفرع عنها: الأول: البياض، وقل أن يخلص من لون يخالطه؛ فإن صفا بياضه قيل فيه: أشهب قرطاسي؛ فإن كان أذناه وقوائمه وعرفه وذيله سوداً قيل: مطرف؛ فإن خالط البياض شعر أسود والأغلب فيه البياض قيل: أشهب كافوري؛ وإن كان السواد فيه أغلب قيل: أشهب حديدي، وأشهب أشمط، وأشهب مخلس؛ فإن كان فيه نكت سود قيل: أشهب مفلس؛ فإن اتسعت قليلاً قيل: أشهب مدنر؛ فإن كان في شهبته طرائق قيل: أشهب مجزع؛ فإن كان فيه بقع من أي لون كان دون البياض قيل: مبقع؛ فإن صغرت تلك البقع قيل: أبقع؛ فإن تفرقت واختلفت مقاديرها قيل: أشيم؛ فإن تعادل ذلك اللون مع البياض مع صغر النقط من اللونين قيل: أنمش؛ فإن تعادل ذلك اللون مع البياض مع صغر النقط من اللونين قيل: أنمش؛ فإن تناهت في الصغر قيل: أبرش؛ فإن كان البياض نكتاً صغيرة في ذلك اللون قيل: مفوف؛ فإن كان شئ من ذلك كله في عضو واحد قيد به مثل قولك: مفوف القطاة، وأنمش الصدر وما أشبه ذلك.الثاني: السواد؛ فإذا كان الفرس شديد السواد قيل فيه: أدهم؛ فإن اشتد سواده قيل: أدهم غيهبي؛ فإن علا السواد خضرة قيل: أحوى والجمع حو؛ فإن خالط سواده شقرة قيل: أدبس؛ فإن انضم إليه أدنى حمرةٍ أو صفرةٍ قيل: أحم؛ فإن ضرب سواده إلى يسير بياض قيل: أورق، ونحوه الأكهب؛ وفي دونه من السواد يقال: أربد.الثالث: الحمرة، إذا كان الفرس خالص الحمرة، وعرفه وذيله أسودان قيل فيه: أورد والجمع وراد والأنثى وردة؛ فإن خالط حمرته سواد فهو كميت، الذكر والأنثى فيه سواء؛ فإن صفت حمرته شيئاً قليلاً قيل: كميت مدمى؛ فإن كان صافياً قليل الحمرة وعرفه وذيله أشقران قيل: أشقر؛ فإن كان أحمر وذيله وعرفه كذلك قيل: أمغر؛ فإن خالط شقرة الأشقر أو اكميت شعرة بيضاء قيل: صنابي، أخذاً من الصناب وهو الخردل بالزبيب؛ فإن كانت حمرته كصدأ الحديد قيل: أصدأ؛ فإن زاد فيه السواد شيئاً يسيراً قيل: أجأى والاسم: الجؤوة.الرابع: الصفرة؛ فإن كانت صفرته خالصة تشبه لون الذهب وعرفه وذيله أصهبان مائلان إلى البياض قيل: أصفر خالص؛ فإن كانا أبيضين قيل: أصفر فاضح؛ فإن كانا أسودين قيل: أصفر مطرف، وهو الذي يسمونه في زماننا الحبشي؛ فإن كان أصفر ممتزجاً ببياض قيل: أشهب سوسني؛ فإن كان في أكارعه خطوط سود قيل: موشي.وأما شياتها وهي البياض المخالف للونها، فمنها: الغرة؛ وهي البياض الذي يكون في وجه الفرس إذا كان قدره فوق الدرهم؛ فإن كان دون الدرهم قيل في الفرس أقرح والعامة تقول فيه: أغر شعرات؛ فإن جاوز البياض قدر الدرهم قيل فيه: أعرم؛ ثم أول رتبة الغرة يقال له: النجم؛ فإن سالت الغرة ورقت ولم تجاوز جبهته قيل فيه: أغر عصفوري؛ فإن تمادت حتى جللت خيشومه ولم تبلغ جحفلته قيل: أغر شمراخي؛ فإن ملأت جبهته ولم تبلغ العينين قيل: أشدخ؛ فإن أصابت جميع وجهه إلا أنه ينظر في سوادٍ قيل: مبرقع؛ فإن فشت حتى جاوزت عينيه وابيضت منها أشفاره قيل: مغرب؛ فإن أصابت منه خداً دون خد قيل: لطيم أيمن أو أيسر؛ فإن كان بشفته العليا بياض قيل: أرثم؛ وإن كان بالسفلى بياض قيل: ألمظ؛ فإن نالهما جميعاً قيل: أرثم المظ.ومنها: التحجيل في الرجلين وما في معنى ذلك؛ إن كان البياض في مؤخر الرسغ لم يستدر عليه قيل في الفرس: منعل؛ وإن كان في الأربع قيل: منعل الأربع؛ أو في بعضها أضيف إليه فقيل: منعل اليدين أو الرجلين أو اليد أو الرجل اليمنى أو اليسرى؛ فإن استدار على الرسغ؛ وهو المفصل الذي يكتنفه الوظيف والحافر وكان في إحدى الرجلين قيل: أرجل؛ وإن كان في الرجلين جميعاً قيل: مخدم وأخدم؛ فإن جاوز رسغ الرجل واتصل بالوظيف؛ وهو ما بين الكعب وبين أسفله ولم يجاوز ثلثيه قيل: محجل، أخذاً من الحجل؛ وهو الخلخال؛ فإن كان في رجل واحدة قيل: محجل الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى؛ فإن كان في الرجلين جميعاً قيل: محجل الرجلين؛ فإن كان معه في إحدى اليدين بياض يجاوز الرسغ إلى دون ثلثي الوظيف قيل: محجل الثلاث مطلق اليد اليمنى أو اليسرى؛ فإن كان البياض في اليد الأخرى كذلك قيل: محجل الأربع؛ فإن كان البياض في اليدين فقط قيل: أعصم، سواء جاوز الرسغ أم لا؛ ولا يطلق التحجيل البياض في اليدين فقط قيل: أعصم، سواء جاوز الرسغ أم لا؛ ولا يطلق التحجيل على اليدين أو إحداهما إلا بانضمام إلى تحجيل الرجلين أو إحداهما؛ فإن كان في اليد الواحدة قيل: أعصم اليد اليمنى أو اليسرى؛ وإن كان فيهما قيل: أعصم اليدين، وإن كان التحجيل في يد ورجل من جانب واحد قيل ممسك؛ وإن كان ذلك من الجانب الأيمن قيل: ممسك الأيامن مطلق الأياسر؛ وإن كان بالعكس قيل: ممسك الأياسر مطلق الأيامن؛ وإن كاالتحجيل في يد ورجل من جانب واحد قيل: ممسك؛ وإن كان ذلك من الجانب الأيمن قيل: ممسك الأيامن مطلق الأياسر؛ وإن كان بالعكس قيل ممسك الأياسر مطلق الأيامن؛ وإن كان التحجيل في يد ورجل من خلاف فهو الشكال؛ وقيل: الشكال بياض القائمتين من جانب، وقيل: بياض ثلاث قوائم؛ فإن تعدى البياض حتى جاوز عرقوبي الرجلين أو ركبتي اليدين قيل فيه: مجبب؛ فإن علا البياض حقوي رجليه ومرفقي يديه قيل: أبلق؛ فإن زاد على ذلك حتى بلغ الأفخاذ والأعضاد قيل: أقفز ومقفز؛ فإن كان البياض في الوظيف غير متصل بالرسغ ولا بالعرقوب ولا بالركبة قيل: موقف.ومنها: الشيات التي تتخلل سائر جسدها؛ فإن كان الفرس مبيض الأذنين أو في أذنيه نقش بياض دون سائر لونه قيل فيه: أذرأ؛ وإن كان مبيض الرأس قيل: أصقع؛ فإ ابيض قفاه قيل: أقنف؛ فإن شابت ناصيته قيل: أسعف؛ فإن ابيضت جميعها قيل: أصبغ الناصية؛ فإن غشى البياض جميع رأسه قيل: أعشى، وربما قيل فيه: أرخم؛ فإن ابيض رأسه وعنقه جميعاً قيل: أدرع؛ فإن أبيض ظهره قيل: أرحل؛ فإن كان ذلك البياض من أثر الدبر قيل: مصرد؛ فإن ابيض بطنه قيل: أنبط؛ فإن ابيض جنباه قيل: أخصف؛ فإن كان البياض بأحد جنبيه قيل: أخصف الجنب الأيمن أو الأيسر؛ فإن ابيض كفله قيل: آزر؛ فإن ابيض عرض ذنبه من أعلاه قيل: أشعل؛ فإن ابيض بعض هلبه دون بعض قيل: مخصل؛ فإن ابيض جميع هلبه قيل: أصبغ هلب الذنب؛ فإن عدا عرقوبه البياض جملة قيل: بهيم ومصمت من أي لون كان.وأما ما يستحسن من أوصافها فقد قال العلماء بأمر الخيل: يستحب في الفرس: دقة الأذنين وطولهما وانتصابهما، ودقة أطرافهما، وقرب ما بينهما؛ وكل ذلك من علامات العتق؛ وفي الناصية: اعتدال شعرها في الطول، بحيث لا تكون خفيفة الشعر ولا مفرطة في كثرته؛ ويقال في هذه: الناصية من الزغب ويستحب: عظم الرأس وطوله وسعة الجبهة، وأسالة الخد، وملاسته، ودقته، وقلة لحم الوجه، وعري الناهضين وهما عظمان في الخد وسعة العين، وصفاء الحدقة؛ وذلك كله من علامات العتق. ويستحب في العين: السمو الحدة ورقة الجفون وبعد نظره.قال ابن قتيبة: وهم يصفونها بالقبل والشوس والخوص، وليس ذلك فيها عيباً ولا هو خلقة، وإنما تفعله نعزة أنفسها. ويستحب في المنخر: السعة، لأنه إذا ضاق شق عليه النفس، قال: وربما شق منخره لذلك وبعد ما بين المنخرين. ويستحب في الفم: الهرت وهو طول شدقيه من الجانبين لأنه أوسع الخروج نفسه، ورقة الجحفلتين وهما الشفتان لأنه دليل العتق، وطول اللسان ليكثر ريقه فلا ينبهر، ورقته لأنه أسرع لقضمه العلف، وصفاء الصهيل لأنه دليل صحة رئته وسهولة نفسه. ويستحب في العنق: الطول، فقد كان سلمان ابن ربيعة يفرق بين العتاق والهجن، فدعا بطست من ماء فوضعت بالأرض ثم قدمت الخيل إليها واحداً واحداً فما ثنى سنبكه منها ثم شرب هجنه؛ وما شرب ولم يثن سنبكه جعله عتيقاً، لأن في أعناق الهجن قصراً فلا تنال الماء حتى تثني سنابكها؛ وقد روي أنه هجن فرس عمرو بن معدي كرب فاستعدى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال سلمان: ادع بإناء فيه ماء! ثم أتي بفرس عتيق لا شك في عتقه فأشرع في الإناء فصف بين سنبكيه ومد عنقه فشرب؛ ثم قال: ائتوني بهجين لا شك فيه! فأشرع فبرك فشرب؛ ثم أتي بفرس عمرو بن معدي كرب فأشرع فصف بين سنبكيه ومد عنقه ثم ثنى أحد سنبكيه قليلاً فشرب؛ فقال عمر: أنت سلمان الخيل.ويستحب فيها مع ذلك الكبر لأنه أقرب لانقياده وعطفه، وغلظ مركب عنقه ودقة مذبحة. ويستحب فيه: ارتفاع الكتفين والحارك والكاهل؛ وقصر الظهر وعرض الصهوة وهي مقعد الفارس في الظهر وارتفاع القطاة وهي مقعد الردف من الظهر أيضاً وقلة لحم المتنين وهما ما تحت دفتي السرج من الظهر.ويستحب في الكفل: الاستواء والاستدارة والملاسة والتدوير. ويستحب: طول السبيب؛ وهو الشعر المسترسل في ذيله، وقصر العسيب؛ وهو عظم الذنب وجلده؛ ولذلك قال بعض الأعراب: اختره طويل الذنب قصير الذنب يعني طويل الشعر قصير العسيب.قال انب قتيبة: ويستحب أن يرفع ذنبه عند العدو، ويقال: إن ذلك من شدة الصلب ويستحب عرض الصدر؛ وهو ما عرض حيث ملتقى أعلى لببه، ويسمى: اللبان والكلكل؛ وكذلك ارتفاعه عن الأرض مع دقة الزور، وهو ما استدق من صدره بين يديه بحيث يقرب ما بين المرفقين لأنه أشد له وأقوى لجريه.ويستحب فيه: عرض الكتف وغلظه وقصر النسا، وهو عرق في الساق مستبطن الفخذ، وشنجه؛ وقصر وظيف اليد؛ وهو قصب يديه، وقصر الرسغ، ودقة إبرة العرقوب وتحديده، لأنه أشد لقصب الساق وطول وظيف الرجل ليخذف الأرض بها فيكون أشد لعدوه، وغلظ عظم القوائم، وغلظ الحبال؛ وهي عصب الذراعين، ولطف الركبة، وقرب ما بين الركبتين، وشدة كعبه، لأن ضعف الكعب داعية الجرد وانحناء الرجلين وتوترهما، وبعد ما بين الرجلين؛ وهو الفحج، لأنه أشد لتمكن رجليه من الأرض. ويستحب: صفاء الحافر، وصلابته، وسعته، وكونه أزرق أو أخضر غير مشوب ببياض؛ لأن البياض دليل الضعف فيه؛ وأن يكون مع ذلك فيه تقعب، ولطف نسوره؛ وهي شئ في باطن حافره كالنوى، لأنه إذا ضاق موضعها كان أصلب لحافره؛ وأن تكون أطراف سنابكه وهي مقادم حوافره رقيقة.ويستحب فيه مع ذلك كله: اتساع إهابه وهو جلده ورقة أديمه، وصفاء لونه، ولين شعره، وكثرة عرفه، وكثرة نومه، وسعة خطوه، وخفة عنانه، ولين ظهره، وحسن استقلاله في أول سيره، وخفة وقع قوائمه على الأرض إذا مشى، وشدة وقعها إذا عدا، مع حدة نفسه وسرعة عدوه، واتساع طرقته؛ وقد يغتفر القطاف في المشي في دواب الجري.ثم إنه قد يحتمل فوات آلة الحسن والفراهة في المشي ولا يغتفر النقص في آلة الجودة وشدة العدو والصبر، لأن بهما يدرك ما يطلب، وينجو مما يهرب.وأما ما يستقبح ويذم من أوصافها، فقد ذكروا للفرس عدة عيوب، بعضها خلقية وبعضها حادثة.فمن العيوب الخلقية: البدد؛ وهو بعد ما بين اليدين، والصمم؛ وهو ألا يسمع وعلامته أن يراه يصر أذنيه أبداً الى خلف، وإذا جر خلفه خشبة ونحوها لا يشعر ولم ينفر عنها؛ والخداء، وهو أن يكون أذناه مسترخيتين منكوستين نحو العينين أو الخدين كآذان الكلاب السلوقية؛ والطول؛ وهو أن تطول إحدى أذنيه وتقصر الأخرى، وكونه أسك؛ وهو أن يكون صغير الأذن.ومنها: السفا؛ وهو قلة شعر الناصية؛ والغمم؛ وهو أن يكثر شعر الناصية، ويطول حتى يغطي العين؛ وهو عيب خفيف؛ والسقا؛ وهو خفة الناصية.ومنها: القرح؛ وهو أن يكون البياض الذي في الوجه دون قدر الدرهم كما تقدم إلا أن يكون معه بياض آخر من تحجيل ونحوه فلا يكره حينئذ؛ فإن كان في وسط البياض في الوجه سواد كان عيباً يتشاءم به.ومنها: العشا؛ وهو ألا يبصر ليلاً فيصير بمثابة نصف فرس، لأنه لا ينتفع به في الليل دون النهار، وكونه قائم العين؛ وهو الذي يكون على ناظره سواد يضرب للخضرة والكدرة يقل معها بصره؛ والحول؛ وهو أن يكون بإحدى عينيه بياض خارج سواد الحدقة من فوق، ويكون خلاف العين الأخرى، وهو مع ذلك مما يتبرك به بعض الناس، ويقول: إذا كان ذلك في العينين كان أعظم لبركته؛ والخيف؛ وهو أن تكون إحدى عينيه زرقاء، وهو مما يتشاءم به لا سيما إذا كانت الزرقة في العين اليسرى، فإن ازرقت العينان جميعاً كان أقل لشؤمه؛ وعور العينين؛ وهو دخولهما في وجهه؛ والغرب؛ وهو بياض أشفار العينين، يكون عنه ضعف بصره في القمر والحر الشديد، والكمنة؛ وهو أن يبصر قدامه، ولا يبصر عن يمينه ولا شماله. ومنها: القنا؛ وهو احديداب في الأنف، ويكون في الهجن؛ والخنس؛ وهو أن يرى فوق منخريه منخسفاً لأنه يضيق نفسه إذا ركض.ومنها: الفطس، وهو أن تكون أسنانه العليا داخلة عن أسنانه السفلى؛ والطبطبة، وهو أن تسترخي جحفلته السفلى فإذا سار حركها وطبطبها كالبعير الأهدل، وأن يكون في حنكه شامة سوداء وسائر فمه أبيض.ومنها: قصر اللسان؛ لأنه إذا قصر لسانه قل ريقه فيسرع إليه العطش، والخرس، وعلامته أن تراه يصهل ولا يحمحم؛ وهو عيب لطيف.ومنها: القصر، وهو غلظ في العنق؛ واللفف، وهو استدارة فيه مع قصر، والدنن، وهو طمأنينة في أصل العنق؛ والهنع؛ وهو طمأنينة في وسط العنق؛ والقود؛ وهو يبس في العنق بحيث لا يقدر الفرس أن يدير عنقه يميناً ولا شمالاً ولا يرفع رأسه إذا مشى؛ وهو عيب شديد؛ والجسأ؛ وهو يبس المعطف.ومنها: الكتف؛ وهو انفراج يكون في أعالي كتفي الفرس مما يلي الكاهل؛ والقعس وهو أن يطمئن الصلب من الظهر وترتفع القطاة، والبزخ، وهو أن يطمئن الصلب والقطاة جميعاً؛ وهو عيب رديء يضر بالعمل؛ وكون الكفل فيه تحديد ويكون العجز صغيراً؛ والفرق؛ وهو نقصان إحدى حرقفتي الوركين، فإن نقصتا جميعاً فهو ممسوح الكفل ولا عيب فيه.ومنها: الدنن؛ وهو تطامن الصدر ودنوه من الأرض؛ وهو من أسوأ العيوب، والزور؛ وهو دخول إحدى فهدتي الصدر وخروج الأخرى.ومنهاك الهضم؛ وهو استقامة الضلوع ودخول أعاليها؛ والإخطاف؛ وهو لحوق ما خلف المحزم من بطنه؛ والثجل، وهو خروج الخاصرة ورقة الصفاق.ومنها: العصل؛ وهو التواء عسيب الذنب حتى يبرز بعض باطنه الذي لا شعر عليه؛ والكشف؛ وهو أكثر من ذلك؛ والصبغ؛ وهو بياض الذنب، والشعل؛ وهو أن يبيض عرض الذنب وهو وسطه.ومنها: الفحج؛ وهو إفراط بعد ما بين الكعبين؛ الحلل؛ وهو رخاوة الكعبين، ويلتحق به تقويس اليدين؛ وهو عيب فاحش، والطرق؛ وهو أن ترى ركبتيه مفسوختين كالمقوستين الى داخل؛ وهو عيب فاحش، والقسط؛ وهو أن ترى رجلاه منتصبتين غير محنبتين؛ والبدد؛ وهو بعد ما بين اليدين؛ والفحج؛ وهو إفراط بعد ما بين العرقوبين، والقفد؛ وهو إنتصاب الرسغ وإقباله على الحافر ولا يكون إلا في الرجل، والصدف؛ وهو تداني الفخذين؛ والتوجيه؛ وهو نحو منه إلا أنه أقل من ذلك؛ والفدع، وهو التواء الرسغ من عرضه الوحشي من الجانبين من رأس الشظي، ووطؤه على وحشي حافريه جميعاً وهو الجانب الخارج؛ والارتهاش؛ وهو أن يصك بعرض حافره عرض عجايته من اليد الأخرى وذلك لضعف يده؛ والحنف، وهو أن يكون حافرا يديه مكبوبين الى داخل؛ والنقد؛ وهو أن يرى الحافر كالمتقشر، والشرج؛ وهو أن يكون ذو الحافر له بيضة واحدة؛ والاح، وهو أن يمس الأرض بباطن حافره.ومنها: البدد في اليدين؛ وهو أن يكون إذا مشى يدير حافره الى خارج عند النقل وليس فيه ضرر في العمل؛ والتلقف، وهو أن يخبط بيديه مستوى لا يرفعهما الى بطنه؛ وهو خلاف البدد.ومنها: التلويح، وهو أن يكون الفرس إذا ضربته حرك ذنبه، وهو عيب فاحش في الحجورة لأنه ربما بالت الحجر ورشت به صاحبتها.الضرب الثاني العيوب الحادثة:وهي عدة عيوب منها: الحدب، ويكون في الظهر بمثابة حدبة الإنسان، وهو عيب فاحش؛ والغدة وتكون في الظهر أيضاً بإزاء السرة.ومنها: العنق؛ وهو انتفاخ وورم بقدر الرمانة أو أقل مما يلي الخاصرة، وهو عيب فاحش لا علاج فيه.ومنها: الحمر؛ وهو عيب يحدث عن تخمة الشعير، وربما كان من شرب الماء على التعب فيحدث عنه ثقل الصدر.ومنها: الانتشار؛ وهو انتفاخ العصب بواسطة التعب، ويكون من فوق الرسغ الى آخر الركبة؛ وهو عيب فاحش.ومنها: تحرك الشظاة، وهو عظم لاصق بالذراع، وهو على الفرس أشق من الانتشار.ومنها: الروح، وهو داء يكون منه غلظ في القوائم كمثل داء الفيل في البشر.ومنها: المشش؛ وهو داء يكون في بدء أمره ماءً أصفر، ثم يصير دماً، ثم يصير عظماً، ويكون على الوظيف وفي مفصل الركبة، وهو على العصب والركبة شر منه على الوظيف.ومنها: القمع، ويكون في الرجلين في طرف العرقوبين؛ وهو غلظ يعتريهما؛ والملح، ويكون في الرجلين تحت القمع من خلف، وهو انتفاخ مستطيل لا يضر بالعمل؛ والجوز؛ وهو كالعظم الناتئ في الرجلين تحت العرقوبين على المفصل من داخل ومن خارج؛ وهو عيب فاحش تؤول منه الدابة الى العطب؛ والنفخ؛ وهو انتفاخ يكون في مواضع الجرذ؛ وهو من دواعي الجرذ؛ والعقال؛ وهو أن تقلص رجله، وذلك يكون في عصب الرجل الواحدة دون الأخرى، وربما كان في الرجلين جميعاً؛ وهو عيب فاحش يضر بالعمل؛ وهو في البرد أشد منه في الحر.ومنها: الشقاق؛ وهو داء يصيبه في أرساغه، وربما ارتفع الى وظيفه؛ والسرطان، وهو داء يأخذ في الرسغ فييبس عروقه حتى ينقلب حافره.ومنها: العرن؛ وهو جسوء في رسغ رجله، والدخس، وهو ورم يكون في حافرهِ؛ والقفد؛ وهو تشنج عصب رسغه حتى ينقلب حافره الى داخل فيمشي على ظاهر الحافر.ومنهاك النملة؛ وهي شق في الحافر من ظاهره؛ والرهسة؛ وهي ما يكون في الحافر من صدمة ونحوها- والعامة تقولها بالصاد- والقشر، وهو أن تتقشر حوافره وهو عيب فاحش؛ والناسور- وهو الذي تسميه العامة الوقرة- وهو داء يحدث في نسور الدابة فإذا قطع سال الدم منه.ومنها: الأدرة؛ وهي عظم الخصيتين؛ وربما عظمت خصيتاه في الصيف واحمرت في الشتاء؛ والمدلي؛ وهو الذي يدلي ذكره ثم لا يرده؛ وهو عيب قبيح بحيث يقبح ركوب الفرس الذي به هذا العيب.ومنها: البرص؛ وهو بياض يعتري الفرس في حركاته كالجحفلة وجفون العينين وبين الفخذين والخصيتين.ومنها: الحلد؛ وهو داء شديد ينقب موضعه من بدن الدابة يسيل منه ماء أصفر، فإذا كوي بالنار برأ وانفتح موضع آخر، فلا يزال كذلك حتى تعطب الدابة؛ وهو عيب فاحش، في عيوب أخرى يطول ذكرها.وفي كتب البيطرة، ذكر الكثير من ذلك مع علاج ماله علاج منه وبيان مالا علاج له.وأما الدوائر التي تكون في الخيل فقد عدها العرب ثماني عشرة دائرةً، بعضها مستحب وبعضها مكروه.الأولى: دائرة المحيا- وهو الوجه- وهي اللاحقة بأسف الناصية. الثانية: دائرة اللطاة؛ وهي دائرة تكون في وسط الجبهة. الثالثة: دائرة النطيح؛ وهي دائرة ثانية في الجبهة بأن يكون في الجبهة دائرتان. الرابعة: دائرة اللهزمة، وهي دائرة تكون في لهزمة الفرس. الخامسة: دائرة المقود؛ وهي التي تكون في موضع القلادة. السادسة: دائرة السمامة، وهي دائرة تكون في وسط العنق. السابعة والثامنة: دائرتان في نحر الفرس فيما قاله الأصمعي.وقال أبو عبيد: البنيقة الشعر المختلف في منتهى الخاصرة والشاكلة.التاسعة: دائر الناحر؛ وهي دائرة في باطن الحلق الى أسفل من ذلك. العاشرة: دائرة تكون في عرض الزور. الثانية عشرة: دائرة النافذة؛ وهي دائرة ثانية تكون في الزور بأن تكون فيه بدائرتان في الشقين في كل شق منهما دائرة؛ وتسمى النافذ، دائرة الحزام أيضاً. الثالثة عشرة والرابعة عشرة: دائرتا الخرب، وهما اللتان يكونان تحت الصقرين وهما رأسا الحجبتين اللتين هما العظمان الناتئان المشرفان على الخاصرتين كأنهما صقران. الخامسة عشرة والسادسة عشرة: دائرتا الصقرين؛ وهما دائرتان بين الحجبتين والقصريين. السابعة عشرة والثامنة عشرة: دائرتان الناخس؛ وهما دائرتان تكونان تحت الجاعرتين.قال ابن قتيبة: وهم يكرهون منها أربع دوائر؛ وهي دائرة الهقعة، مع ذكره أن أبقي الخيل: المهقوع. ودائرة القالع، ودائرة الناخس، ودائرة النطيح. قال: وما سوى ذلك من الدوائر فليس بمكروه.وذكر صاحب زهر الآداب في اللغة: أنهم يستحبون من الدوائر دائرة المقود؛ ودائرة السمامة؛ ودائرة الهقعة، احتجاجاً بأن أبقى الخيل المهقوع؛ ويكرهون دائرة النطيح، ودائرة اللهزمة، ودائرة القالع.ورأيت في بعض كتب البيطرة، أن المستحب منها ثلاث دوائر: دائرة المقود، ودائرة السمامة، ودائرة الهقعة؛ وما عدا ذلك فهو مكروه.وكره حكماء الهند دوائر أخرى ذكروها؛ وهي أن يكون في مقدم يده دائرة، أو في أصل ذنبه من الجانبين دائرتان أو على ناصيته دائرة، أو على محجره دائرة، أو في جحفلته السفلى دائرة، أو على سرته دائرة، أو على منسجه دائرتان.وأما أسنان الخيل: فأول ما تضع الحجرة جنينها قيل: مهر، والأنثى مهرة؛ فإذا فصل عن أمه قيل: فلو؛ فإذا استكمل حولاً قيل: حولي والأنثى حولية؛ فإذا دخل في الثانية قيل: جذع والأنثى جذعة، فإذا دخل في الثالثة قيل: ثني والأنثى ثنية؛ فإذا دخل في الرابعة قيل: رباع والأنثى رباعية؛ فإذا دخل في الخامسة قيل: قارح للذكر والأنثى.وفي الغالب يلقي أسنانه في السنة الثالثة، وربما تأخر إلقائها الى السنة الرابعة؛ وذلك إذا كان أبواه شابين، وقد يلقي أسنانه في حول واحد؛ وذلك إذا كان أبواه هرمين. ثم لكل مهر اثنتا عشرة سناً: ست من فوق وست من أسفل، ويليها من كل جانب ناب، ويليها الأضراس، وتنبت ثناياه، بعد وضعه بخمسة أيام وتنبت رباعياته بعد ذلك الى مدة شهرين؛ وتنبت قوارحه بعد ذلك الى ثمانية أشهر؛ ويختص التبديل منها بالأسنان الأثنتي عشرة دون الأنياب والأضراس. وربما ألقي بالمهر بعض أسنانه، ثم لاتنبت؛ وإذا قرح المهر اصفرت أسنانهن وأسودت رؤوسها وطالت فيبقى كذلك خمس سنين؛ فإذا جاوزت ذلك ابيضت وحفي رؤوسها، ثم تنتقل فتصير كلون العسل خمس سنين، ثم تبيض فتصير كلون الغبار ويزداد طولها؛ وربما دلس النخاسون فنشروا أسنانها وسووها.ومما وجد في الكتب القديمة: أن الفرس تتحرك ثناياه في سبع وعشرين سنة؛ وتتحرك الرباعيات في ثمان وعشرين سنة، وتتحرك القوارح في تسع وعشرين سنة؛ ثم تسقط الثنايا في ثلاثين سنة، والرباعيات في إحدى وثلاثين سنة، والقوارح في اثنتين وثلاثين سنة هو عمر الدابة.وأما التفرس في الخيل: فاعلم أن المهر وإن المهر وإن ظهرت فيه علامات النجابة أو العكس لا عبرة بذلك، فإنه قد يتغير فيقبح منه ما كان حسناً، ويحسن منه ما كان قبيحاً؛ وإنما يتفرس فيه إذا ركبه لحم العلف، وذهب عنه لحم الرضاع.وأفضل الفراسة في المهر: أخذه في الجري، فإنه صنعته التي خلق عليها وإليها يؤول، فإذا أحسن الأخذ في الجري فهو جواد؛ ولكنه ربما تغير أخذه للجري إذا ركب لضعف فيه بحينئذ، وقصور عن بلوغ مدى قوته؛ وقد لا يجري جذعاً ويجري ثنياً، وقد لا يجري ثنياً ويجري رباعياً، وقد لا يجري رباعياً ويجري قارحاً حين تجتمع له قوته. ويعرف ضعف الضعيف منها بتلوية تحت فارسه وعجزه عنه وفترته إذا نزل عنه.ومما يدل على جودة الفرس وحسن جريه: أنه يراه إذا أخذ في الجري سما بهادية، وأثبت رأسه، ولم يستعن بهما في حضره واجتمعت قوائمه، وسبح بيديه وضرح برجليه، ولها في حضره، وامتد، وبسط ضبعيه حتى لا يجد مزيداً، وتكون يداه في قرن ورجلاه في قرن؛ فإذا كان الفرس كذلك فهو الجواد السابق.وقد قيل: إن خير الخيل الذي إذا مشى تكفأ، وإذا عدا بسط يديه، وإذا أدبر جفا، وإذا أقبل أقعى.الصنف الثاني: البغال:وفيها نوعية في الخيل والحمير، ومن حيث أنها تتولد بين حصان وأتان، أو بين حمار وحجرة. وفيها النفيس المختار لركوب الرؤساء من العلماء، والوزراء، والحكام وسائر رؤساء المتعممين. وإنه صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كان راكباً بغلة، ولولا شرفها ونفاستها وقيامها مقام الخيل لما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الحرب. وألوانها وأسنانها على ما تقدم في الخيل.ويستحسن فيها غالب ما يستحسن في الخيل؛ وقد قيل: إن خيار ما يقتني من البغال ما اشتدت قوائمه وعظمت قصرته، وعنقه وهامته، وصفت عيناه، ورحب جوفه، وعرض كفله، وسلم من جميع العيوب والعلل.ومما يستحسن في البغال دون الخيل: السفا؛ وهو خفة شعر الناصية؛ وأن يكون بيديها ورجليها خطوط مختلفة، جل ما تكون للسنور، ويقال: إن خير ما يختار للسرج والركوب البغال المصرية، لأن أمهاتها عتاق وهجن؛ وخيار ما يحتاج إليه للسرايا والمواكب والركض مع الخيل: بغال الجزيرة وإفريقية.ومما ينبغي التنبيه عليه: أن في البغلات منها شدة محبة الدواب إذا ربطت معها، وفساد للدواب إذا اعتادتها حتى يصير أحدهما لا يفارق الآخر إلا بمشقة.ويحسن في البغال: الخصي، وفي البغلات: التحويص. ولا يعاب ركوب شيء منها حينئذ إذا كان نفيساً.الصنف الثالث: الإبل:ويشتمل الغرض منها على معرفة أنواعها، وألوانها، وأسنانها؛ وما يستقبح ويستحسن من صفاتها.أما أنواعها فإنها ترجع الى نوعين:الأول: البخاتي؛ وهي جمال جفاة القدود، طويلة الوبر، تجلب من بلاد الترك.الثاني: العراب؛ وهي الإبل العربية وأصنافها لا يأخذها الحصر. وأما ألوانها فترجع الى ثلاثة أصول: الأول: البياض، فاجمل إذا كان خالص البياض قيل: آدم والأنثى أدماء على الضد من بني آدم؛ فإن خالط البياض يسير شقرة قيل: أعيس والأنثى عيساء.الثاني: الحمرة، فإن احمر وغلبت عليه الشقرة قيل: أصهب والأنثى صهباء؛ فإن خلصت حمرته قيل: أحمر والأنثى حمراء؛ فإن خالط حمرته قنوء قيل: كميت؛ فإن صفت حمرته قيل: أحمر مدمى؛ فإن خالط الحمرة خضرة قيل: أحوى؛ فإن خالطها صفرة قيل: أحمر رادني بكسر الدال؛ فإن خالطها سودا قيل: أرمك والأنثى رمكاء؛ فإن كانت حمرته كصدأ الحديد قيل: أجأى.الثالث: السواد، فإن كان السواد فيه بضعيفاً قيل: أكلف؛ فإن خالط السواد صفرة قيل: أحوى، فإن علق بسوداه بياض قيل: أورق؛ فإن زادت ورقته حتى أظلم بياضه قيل: أدهم؛ فإن اشتد سواده قيل: جون، فإن كان بين الغبرة والحمرة قيل: خوار والأنثى خوارة.وأما أسنانها فإنه يقال لولد الناقة عند الوضع قبل أن يعرف أذكر أم أنثى: سليل؛ فإن بان أنه ذكر قيل: سقب؛ وإن بان أنه أنثى قيل: حائل، ثم هو حوار حتى يفطم؛ فإذا فطم وفصل عن أمه قيل: فصيل؛ وذلك في آخر السنة الأولى من وضعه؛ فإذا دخل في الثانية قيل: ابن مخاض؛ لأن أمه فيها تكون من المخاض وهي الحوامل والأنثى بنت مخاض؛ فإذا دخل في الثالثة قيل: ابن لبون؛ لأن أمه فيها تكون ذات لبن والأنثى حقة؛ فإذا دخل في الرابعة قيل: حق، لأنه يستحق أن يحمل عليه والأنثى حقة؛ فإذا دخل في الخامسة قيلك حذع والأنثى جذعة؛ فإذا دخل في السادسة قيل: ثني، لأنه يلقي فيها ثنيته والأنثى ثنية؛ فإذا دخل في السابعة قيل: رباع بفتح الراء لأن فيها يلقي رباعيته والأنثى رباعية بالتخفيف؛ فإذا دخل في الثامنة قيل: رباع بفتح الراء لأن فيها يلقي رباعيته والأنثى رباعية بالتخفيف؛ فإذا دخل في الثامنة قيل: سديس وسديس، الذكر والأنثى فيه سواء، وربما قيل في الأنثى سديسة؛ فإذا دخل التاسعة قيل: بازل، لأنه فيها يبزل نابه، والذكر والأنثى فيه سواء؛ وقد يقال فيه: فاطر؛ فإذا دخل في العاشرة قيل: مخلف؛ وليس وراء للإبل ضبط بل يقال مخلف عامٍ ومخلف عامين فأكثر؛ فإذا علا السن بعد ذلك قيل فيه: عود والأنثى عودة؛ فإن علا عن ذلك قيل: قحر؛ فإن تكسرت أنيابه لطول هرمه قيل: ثلب والأنثى ثلبة؛ ويقال في الناقة إذا كان فيها بعض الشباب: عزوم، وربما قيل: شارف.وأما ما يستحسن من صفاتها فقد رأيت في بعض المصنفات أن كل ما يستحب في الفرس يستحب في البعير خلا عرض غاربه، وفتل مرفقه، ونكس جاعرته وهي أعلى الورك، واندلاق بطنه، وتفرش رجليه، فإن ذلك يستحب في الإبل دون الخيل.وقد صرح الشعراء في أشعارهم بعدة أوصاف مستحسنة في الناقة.منها: دقة الأذن، وتحديد أطرافها، وكبر الرأس، واستطالة الوجه، وعظم الوجنتين؛ وقنو الأنف، وطول العنق، وغلظه، ودقة المذبح، وطول الظهر، وعظم السنام وهي: الكوماء وطلو ذنبها، وكثرة شعره؛ غليظة الأطراف، قليلة لحم القوائم؛ ليست رهلة، ولا مسترطيةً؛ وأن تكون مع ذلك كثيرة اللحم؛ ملساء الجلد، تامة الخلق، قوية، صلبة، خفيفة سريعة السير.وأما كرمها فإنه يقال لكل كريم خالص من الإبل: هجان من نتاج مهرة: وهي قبيلة من قضاعة باليمن؛ والعيدية منسوبة الى بني العيد من قبيلة مهرة المذكورة؛ والأرحبية منسوبة الى بني أرحب؛ والغريري منسوبة الى غرير؛ وهو فحل كريم مشهور في العرب؛ والشذقمية منسوبة الى شذقم: فحل كريم أيضاً، والجديلية منسوبة الى جديل: فحل كريم؛ والداعرية منسوبة الى داعر: فحل كريم كذلك. قال في كفاية المتحفظ: والشدنية منسوبة الى فحل أو بلد.الصنف الرابع: الحمير:ومنها النفيس الغالي الثمن، وخيرها حمر الديار المصرية، وأحسنها ما أتي به من صعيدها؛ وهي تنتهي في الأثمان الى ما يقارب أثمان أوساط الخيل، وربما يميز العالي القدر منها على المنحط القدر من الخيل. والأحسن فيها ما كان غليظ القوائم، تام الخلق، حديد النفس.ولا عيب في ركوب الحمار ولا وهيصة؛ فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار؛ ولا عبرة بترفع من ترفع عن ركوبه بعد أن ركبه النبي صلى الله عليه وسلم.